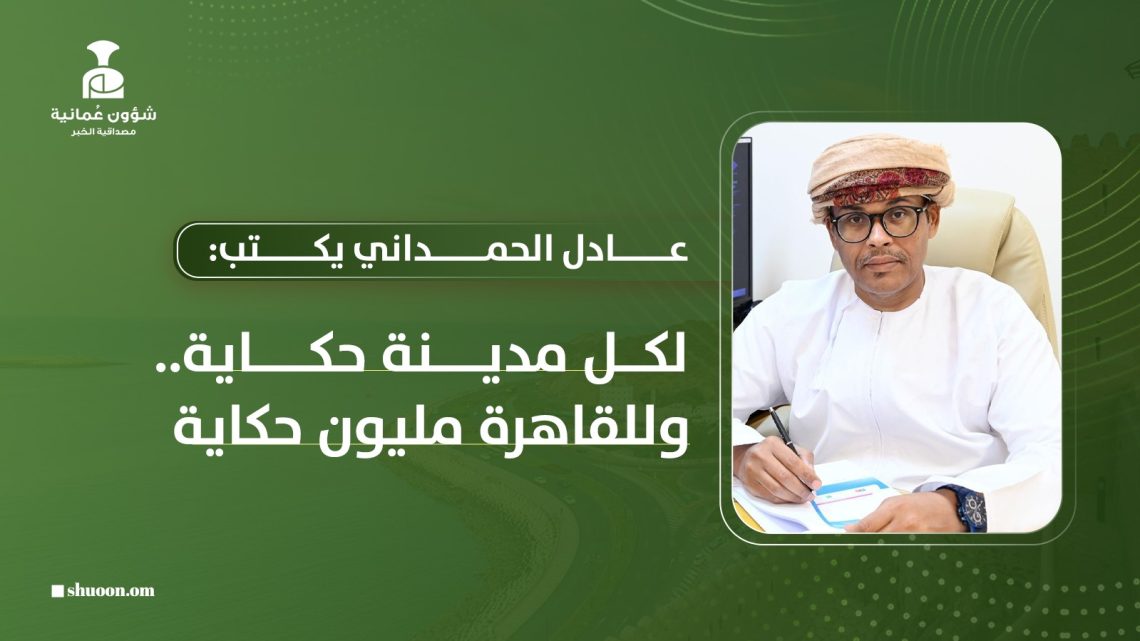عادل الحمداني/ أديب وكاتب عُماني
الدهشة واحدة من تلك المشاعر التي يعجز القلم عن الإمساك بتفاصيلها. والدهشة التي تصنعها بعض المدن – مثل القاهرة – أشد استعصاءً على الوصف. فهذه مدينة يمكنك أن تزورها ألف مرة، وفي كل مرة تشعر وكأنك تطأ أرضها لأول مرة.
حين تكون في القاهرة يُخالجك شعور غامض بأن صوتًا ما يهمس لك، يغرقك في دهشة ممتدة. ومن لا يسمع صوت القاهرة لا يمكنه أن يدرك ما تخبئه بين جنباتها. هنا، تتقاطع الأزمنة كما تتقاطع الكباري والطرقات والأمواج البشرية عبر ضفتي النيل الخالد في الذاكرتين العربية والعالمية على حد سواء.
لم أكن أدرك، وأنا أعبر مدخل المغادرين في مطار مسقط الدولي متجهًا إلى القاهرة، أنني سأحمل تلك الدهشة من جديد. زرت هذه المدينة مرات عديدة، ومع ذلك كانت القاهرة تقول لي بطريقتها الخاصة: “عجز من سبقك عن فهم تركيبتي المتفردة. فلا تُتعب نفسك؛ فأنت لست إلا أحد عُشّاقي الكُثر”.
ما بين مسقط والقاهرة زمن يقدّر بنحو خمس ساعات طيران، لكنه ليس مجرد انتقال جغرافي؛ هو انتقال بين تاريخ بلدين عريقين، ورحلة بين هيئات فكرية وثقافية وحضارية تمتلك كل منهما تفردها الخاص. كنا – نحن الصحفيين المتجهين للمشاركة في دورة “توظيف الوسائط الرقمية في فنون التحرير الصحفي” – نحمل حماسة الباحث عن معرفة جديدة. لكن “عزيز” تحديدًا، في زيارته الأولى، كان يحمل لهفة واضحة للعيش وسط أهل المدينة ورؤية تفاصيل القاهرة التي قيل له إنها لا تنام، مدينة صاخبة بضجيج لا مثيل له. وكان من أخبره صادقًا؛ فالقاهرة لا تستقبل زائرها إلا بضجيج المحب وإيقاع الحياة المتجدد، وبتفاصيل تكاد تكون متشابهة في كل ركن وزاوية من زواياها.
القاهرة مدينة لا تسمح لك أن تُغمض عينيك كي لا يفوتك شيء فيها. ولم أكن بحاجة أن أخبر “عزيز” بأنها ستعلّمه ما لا يمكن أن يتعلمه من كتاب أو قاعة دراسية، لذلك اكتفيت بالصمت أمام أسئلته التي لا تنتهي، ووجّهت بصري إلى شاشة تتبع خط الرحلة.
وحين حطت الطائرة على أرض مطار القاهرة، انتفضت الأنفس شوقًا. ترددت كلمات الشكر والحمد، وراح آخرون يحدقون عبر النوافذ يستعيدون ذكريات زيارات سابقة، فيما عمّ صمت لحظة اللقاء الأول. وحدها العيون بقيت ترصد وتلتقط وتخزن مشاهد اللحظة.
فجأة سألني “عزيز” السؤال الذي توقعت أن يطرحه: “هل تكفي خمسة أيام لأعرف هذه المدينة؟” ابتسمت قبل أن أجيبه: “القاهرة تفتح قلبها لمن يزورها. استغل وقتك جيدًا، واستحضر ذاكرة جديدة… فربما تلتقط بعضًا منها.” ثم أردف بسؤال آخر: “وكيف تتوقع استفادتي من الدورة التدريبية؟” أجبته بثقة من خبر نفس التجربة: “أكبر فائدة ستحصل عليها… هي القاهرة نفسها.” كنت أريد أن أضيف: “القاهرة لا تتركك سائحًا عابرًا، بل تحولك إلى جزء من حكاياتها. القاهرة تأخذك إلى فصول حكاية جديدة، ترسم خطوطها بنفسك، تصور تفاصيلها، تخزّن في ذاكرتك شخوصها وأحاديثها” لكني قررت تركه يكتشف ذلك بنفسه.
كانت الوجهة الأولى “وسط البلد”، شارع طلعت حرب تحديدًا، حيث الإقامة على مقربة من نقابة الصحفيين. هناك تتجلى القاهرة في أجمل صورها: نهر من النور المندلق عبر الزمن، نور لا يؤذي العين، تستشعر وهجه على جسدك دون أن تستهجنه. هناك حركة حياة لا تهدأ، وتاريخ يهمس في أذنك: “هنا القاهرة… المدينة التي لا تغفل عمّا حولها”.
كان لابد لي، أنا العاشق لكل ذاك الضجيج، أن أحجز لنفسي غرفة تطل على الشارع بشرفة تتيح لي رؤية الناس في ذهابهم وإيابهم. أصوات تتداخل، وضجيج ينساب بنكهته المبهجة، وحياة تتسق مع شخوص “عمارة يعقوبيان” على الطرف ذاته، ومع كتب “مكتبة مدبولي” الواقفة بشموخ أمام ميدان طلعت حرب.
منذ وصولنا، لم تعد الدورة التدريبية هي المصدر الوحيد للمعرفة. مصر بأكملها درس مفتوح: وجوه الناس، أصواتهم، ضجيج الطرقات، حوارات سائقي الأجرة، الأسواق الشعبية… كلها حكايات تنسجها المدينة وتقدمها بسخاء لمن يفتح عينيه جيدًا. حكايات ترويها مدينة، أراها فاتحة قلبها قبل ذراعيها.
بالنسبة لي لم تعد القاهرة جديدة عليّ، لكنني في كل مرّة أراها متغيرة. في زيارتي الأخيرة، كان “المتحف المصري الكبير” أبرز إضافة للمدينة. هناك، تشعر وكأن التاريخ يمد يديه ليحتضنك، ليقول لك: “تعال وانظر… فهذه مصر التي لا تنتهي. تعال لترى حكايات مصر القديمة”. مصر وليست القاهرة وحدها، تغسلك من الداخل، تعيد ترتيب أفكارك، تشعل فيك حنينا لشيء ما لا تعرف ما هو، غير أنك تدرك أنك في حضرة زمن قُدّر له أن يكون بلا نهاية.
أما الأهرامات، فهي ليست حجارة صامتة؛ إنها نبض حيّ أكبر من أي وصف. ونحن في العربة الخشبية التي يجرها الحصان، كانت قلوبنا تتراقص قبل أجسادنا، ومعها تتراقص مشاعرنا نحن المندهشين فرحا وسرورا، ووجوهنا، حينئذ، ضاحكة مستبشرة. أكاد أجزم لو أن الأهرامات نطقت لقالت: “اكتب ما تشاء، لن توفّي ما تراه حقه. أكتب فقد تقترب من دقة الوصف. أتحداك أن تقدر على رصد كل التفاصيل، أكتب فنحن لا نريد أن نحبطك. هناك أربعة أشياء في هذا العالم لا يمكنك إخفاؤها: الشمس، القمر، الحقيقة، و…… جمال القاهرة”.
كان لابد من جلسة مع “إبراهيم” و”خالد” في مقاهي العتبة والحسين وخان الخليلي، فيما يمسك “عزيز” بيد “محفوظ” لشراء هدايا وتذكارات. هناك تتلوى الأزقة كأنهار متقاطعة، ويُنسج الدفء من ضحكات الباعة، وروائح الشاي، وهمسات الماضي التي لا تزال تعيش بين الجدران.
وفي المقهى الذي جلسنا فيه، غزا الشيب رؤوس الحاضرين لكن الضحكات لم تغادر وجوههم. كل حكاية أطول من الوقت، وكل فنجان قهوة يفتح بابًا لذكرى جديدة. التقطت الصور، وتشبعت بالحياة التي أحبها في مصر، وازددت يقينًا بأن القاهرة درس جميل لإعادة اكتشاف الذات وتجربة تستحق خوض غمارها.
كل مرة أزور فيها القاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما من المدن المصرية، أزداد يقينًا بأن المدن التي نحبها لا تغادرنا. نبقى فيها بقلوبنا ولهفتنا. المدن التي نحبها، هي الأخرى، لا تغادرنا، تظل حاضرة معنا في ذاكرتنا، في تفاصيل لحظاتنا التي عشنا فيها، في الأشياء التي نحملها بين أيدينا ونحن عائدون إلى وطننا. وهذا أنا ما إن وصلت إلى مسقط حتى تملكتني الرغبة في العودة إليها.
هذه القاهرة لو أردت أن أكتب فيها مقالا أو منها رواية لن أقدر أن أوفيها حقها. ما زلت مسكونا بالدهشة أمامها. القاهرة مدينة يمكن كتابتها بأكثر من طريقة، كلها تصب في خانة “القاهرة”.
القاهرة مدينة تُكتب ألف مرة… وفي كل مرة تقول لك: “لم تبدأ الكتابة بعد.”